جاء في تفسير الميزان للسيد الطباطبائي: قوله تعالى "قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ۚ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ ۚ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ۚ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ" ﴿هود 88﴾ المراد بكونه على بينة من ربه كونه على آية بينة وهي آية النبوة والمعجزة الدالة على صدق النبي في دعوى النبوة، والمراد بكونه رزق من الله رزقا حسنا أن الله آتاه من لدنه وحي النبوة المشتمل على أصول المعارف والشرائع، وقد مر توضيح نظير هاتين الكلمتين فيما تقدم. والمعنى: أخبروني إن كنت رسولا من الله إليكم وخصني بوحي المعارف والشرائع وأيدني بآية بينة يدل على صدق دعواي فهل أنا سفيه في رأيي؟ وهل ما أدعوكم إليه دعوة سفهية؟ وهل في ذلك تحكم مني عليكم أو سلب مني لحريتكم؟ فإنما هو الله المالك لكل شيء ولستم بأحرار بالنسبة إليه بل أنتم عباده يأمركم بما شاء، وله الحكم وإليه ترجعون. وقوله: "وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ" تعدية المخالفة بإلى لتضمينه معنى ما يتعدى بها كالميل ونحوه؟ والتقدير: أخالفكم مائلا إلى ما أنهاكم عنه أو أميل إلى ما أنهاكم عنه مخالفا لكم. والجملة جواب عن ما اتهموه به أنه يريد أن يسلب عنهم الحرية في أعمالهم ويستعبدهم ويتحكم عليهم، ومحصله أنه لو كان مريدا ذلك لخالفهم فيما ينهاهم عنه، وهو لا يريد مخالفتهم فلا يريد ما اتهموه به وإنما يريد الإصلاح ما استطاع. توضيحه: أن الصنع الإلهي وإن أنشأ الإنسان مختارا في فعله حرا في عمله له أن يميل في مظان العمل إلى كل من جانبي الفعل والترك فله بحسب هذه النشأة حرية تامة بالقياس إلى بني نوعه الذين هم أمثاله وأشباهه في الخلقة لهم ما له وعليهم ما عليه فليس لأحد أن يتحكم على آخر عن هوى من نفسه. إلا أنه أفطره على الاجتماع فلا تتم له الحياة إلا في مجتمع من أفراد النوع يتعاون فيه الجميع على رفع حوائج الجميع ثم يختص كل منهم بما له من نصيب بمقدار ما له من الزنة الاجتماعية، ومن البديهي أن الاجتماع لا يقوم على ساق إلا بسنن وقوانين تجري فيها، وحكومة يتولاها بعضهم تحفظ النظم وتجري القوانين كل ذلك على حسب ما يدعو إليه مصالح المجتمع. فلا مناص من أن يفدي المجتمعون بعض حريتهم قبال القانون والسنة الجارية بالحرمان من الانطلاق والاسترسال ليسعدوا لذلك بنيل بعض مشتهياتهم وإحياء البعض الباقي من حريتهم.
وعن مصالح المجتمع ومنافعه في موضوع الأمر والنهي يقول السيد العلامة الطباطبائي: فالإنسان الاجتماعي لا حرية له قبال المسائل الحيوية التي تدعو إليه مصالح المجتمع ومنافعه، والذي يتحكمه الحكومة في ذلك من الأمر والنهي ليس من الاستعباد والاستكبار في شيء إذ إنها إنما يتحكم فيما لا حرية للإنسان الاجتماعي فيه، وكذا الواحد من الناس المجتمعين إذا رأى من أعمال إخوانه المجتمعين ما يضر بحال المجتمع أو لا ينفع لإبطاله ركنا من أركان المصالح الأساسية فيها فبعثه ذلك إلى وعظهم بما يرشدهم إلى اتباع سبيل الرشد فأمرهم بما يجب عليهم العمل به ونهاهم عن اقتراف ما يجب عليهم الانتهاء عنه لم يكن هذا الواحد متحكما عن هوى النفس مستعبدا للأحرار المجتمعين من بني نوعه فإنه لا حرية لهم قبال المصالح العالية والأحكام اللازمة المراعاة في مجتمعهم، وليس ما يلقيه إليهم من الأمر والنهي في هذا الباب أمرا أو نهيا له في الحقيقة بل كان أمرا ونهيا ناشئين عن دعوة المصالح المذكورة قائمين بالمجتمع من حيث هو مجتمع بشخصيته الوسيعة، وإنما الواحد الذي يلقي إليهم الأمر والنهي بمنزلة لسان ناطق لا يزيد على ذلك. وأمارة ذلك أن يأتمر هو نفسه بما يأمر به وينتهي هو نفسه عما ينهى عنه من غير أن يخالف قوله فعله ونظره عمله، إذ الإنسان مطبوع على التحفظ على منافعه ورعاية مصالحه فلو كان فيما يدعو إليه غيره من العمل خير وهو مشترك بينهما لم يخالفه بشخصه، ولم يترك لنفسه ما يستحسنه لغيره، ولذلك قال عليه السلام فيما ألقاه إليهم من الجواب:" وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ" ﴿هود 88﴾ وقال أيضا كما حكاه الله تتميما للفائدة ودفعا لأي تهمة تتوجه إليه: "وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين" الشعراء 180).
وعن علاقة النهي بأمر الاصلاح يقول العلامة الطباطبائي في تفسير الآية هود 88: فهو عليه السلام يشير بقوله: "وما أريد أن أخالفكم" ﴿هود 88﴾ إلخ، إلى أن الذي ينهاهم عنه من الأمور التي فيها صلاح مجتمعهم الذي هو أحد أفراده، ويجب على الجميع مراعاتها وملازمتها، وليس اقتراحا استعباديا عن هوى من نفسه، ولذلك عقبه بقوله: "إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ" ﴿هود 88﴾. وملخص المقام أنهم لما سمعوا من شعيب عليه السلام الدعوة إلى ترك عبادة الأصنام والتطفيف ردوه بأن ذلك اقتراح منه مخالف لما هم عليه من الحرية الإنسانية التي تسوغ لهم أن يعبدوا من شاءوا ويفعلوا في أموالهم ما شاءوا. فرد عليهم شعيب عليه السلام بأن الذي يدعوهم إليه ليس من قبل نفسه حتى ينافي مسألتهم ذلك حريتهم ويبطل به استقلالهم في الشعور والإرادة بل هو رسول من ربهم إليهم وله على ذلك آية بينة، والذي أتاهم به من عند الله الذي يملكهم ويملك كل شيء وهم عباده لا حرية لهم قباله، ولا خيرة لهم فيما يريده منهم. على أن الذي ألقاه إليهم من الأمور التي فيها صلاح مجتمعهم وسعادة أنفسهم في الدنيا والآخرة، وأمارة ذلك أنه لا يريد أن يخالفهم إلى ما ينهاهم عنه بل هو مثلهم في العمل به، وإنما يريد الإصلاح ما استطاع، ولا يريد منهم على ذلك أجرا إن أجره إلا على رب العالمين. وقوله: "وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ" ﴿هود 88﴾ في مقام الاستثناء من الاستطاعة فإنه عليه السلام لما ذكر لهم أنه يريد إصلاح مجتمعهم بالعلم النافع والعمل الصالح على مقدار ما له من الاستطاعة وفي ضوئها أثبت لنفسه استطاعة وقدرة وليست للعبد باستقلاله وحيال نفسه استطاعة دون الله سبحانه أتم ما في كلامه من النقص والقصور بقوله:"وما توفيقي إلا بالله" أي إن الذي يترشح من إرادتي باستطاعة مني من تدبير أمور مجتمعكم وتوفيق الأسباب بعضها ببعض الناتجة لسعادته إنما هو بالله سبحانه لا غنى عنه ولا مخرج من إحاطته ولا استقلال في أمر دونه فهو الذي أعطاني ما هو عندي من الاستطاعة، وهو الذي يوفق الأسباب من طريق استطاعتي فاستطاعتي منه وتوفيقي به.
والتوفيق لا يأتي الا بعد الاصلاح كما قال العلامة السيد الطباطبائي في تفسير الميزان: بين عليه السلام هذه الحقيقة، واعترف بأن توفيقه بالله، وذلك من فروع كونه تعالى هو الفاطر لكل نفس والحافظ عليها والقائم على كل نفس بما كسبت كما قال: "الحمد لله فاطر السماوات والأرض" (فاطر 1)، وقال: "وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ" (سبأ 21)، وقال:" أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ:" (الرعد 33)، وقال: "إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا" (فاطر 41) ومحصله أنه تعالى هو الذي أبدع الأشياء وأعمالها والروابط التي بينها وأظهرها بالوجود، وهو الذي قبض على كل شيء فأمسكه وأمسك آثاره والروابط التي بينها أن تزول وتغيب وراء ستر البطلان. ولازم ذلك أنه تعالى وكيل كل شيء في تدبير أموره فهي منسوبة إليه تعالى في تحققها وتحقق الروابط التي بينها لما أنه محيط بها قاهر عليها ولها مع ذلك نسبة إلى ذلك الشيء بإذنه تعالى. ومن الواجب للعبد العالم بمقام ربه العارف بهذه الحقيقة أن يمثلها بإنشاء التوكل على ربه والإنابة والرجوع إليه، ولذلك لما ذكر شعيب عليه السلام أن توفيقه بالله عقبه بإنشاء التوكل والإنابة فقال: "عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ" ﴿هود 88﴾.
وعن حرية الإنسان في عمله في التبيين والنهي والإصلاح يقول العلامة الطباطبائي في ذيل تفسير الآية هود 88: الإنسان بحسب الخلقة موجود ذو شعور وإرادة له أن يختار لنفسه ما يشاء من الفعل وبعبارة أخرى له في كل فعل يقف عليه أن يختار جانب الفعل وله أن يختار جانب الترك فكل فعل من الأفعال الممكنة الإتيان إذا عرض عليه كان هو بحسب الطبع واقفا بالنسبة إليه على نقطة يلتقي فيها طريقان: الفعل والترك فهو مضطر في التلبس والاتصاف بأصل الاختيار لكنه مختار في الأفعال المنتسبة إليه الصادرة عنه باختياره أي إنه مطلق العنان بالنسبة إلى الفعل والترك بحسب الفطرة غير مقيد بشيء من الجانبين ولا مغلول، وهو المراد بحرية الإنسان تكوينا. ولازم هذه الحرية التكوينية حرية أخرى تشريعية يتقلد بها في حياته الاجتماعية وهو أن له أن يختار لنفسه ما شاء من طرق الحياة ويعمل بما شاء من العمل، وليس لأحد من بني نوعه أن يستعلي عليه فيستعبده ويتملك إرادته وعمله فيحمل بهوى نفسه عليه ما يكرهه فإن أفراد النوع أمثال لكل منهم ما لغيره من الطبيعة الحرة، قال تعالى: "وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ" (آل عمران 64) وقال: "وما كان لبشر" إلى أن قال "ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله" (آل عمران 79). هذا ما للإنسان بالقياس إلى أمثاله من بني نوعه، وإما بالقياس إلى العلل والأسباب الكونية التي أوجدت الطبيعة الإنسانية فلا حرية له قبالها فإنها تملكه وتحيط به من جميع الجهات وتقلبه ظهرا لبطن، وهي التي بإنشائها ونفوذ أمرها فعلت بالإنسان ما فعلت فأظهرته على ما هو عليه من البنيان والخواص من غير أن يكون له الخيرة من أمره فيقبل ما يحبه ويرد ما يكرهه بل كان كما أريد لا كما أراد حتى إن أعمال الإنسان الاختيارية وهي ميدان الحرية الإنسانية إنما تطيع الإنسان فيما أذنت فيه هذه العلل والأسباب فليس كل ما أحبه الإنسان وأراده بواقع ولا هو في كل ما اختاره لنفسه بموفق له، وهو ظاهر. وهذه العلل والأسباب هي التي جهزت الإنسان بجهازات تذكره حوائجه ونواقص وجوده، وتبعثه إلى أعمال فيها سعادته وارتفاع نواقصه وحوائجه كالغاذية مثلا التي تذكره الجوع والعطش وتهديه إلى الخبز والماء لتحصيل الشبع والري وهكذا سائر الجهازات التي في وجوده. ثم إن هذه العلل والأسباب أوجبت إيجابا تشريعيا على الإنسان الفرد أمورا ذات مصالح واقعية لا يسعه إنكارها ولا الاستنكاف بالاستغناء عنها كالأكل والشرب والإيواء والاتقاء من الحر والبرد والدفاع تجاه كل ما يضاد منافع وجوده. ثم أفطرته بالحياة الاجتماعية فأذعن بوجوب تأسيس المجتمع المنزلي والمدني والسير في مسير التعاون والتعامل، ويضطره ذلك إلى الحرمان عن موهبة الحرية من جهتين: إحداهما أن الاجتماع لا يتم من الفرد إلا بإعطائه الأفراد المتعاونين له حقوقا متقابلة محترمة عنده ليعطوه بإزائها حقوقا يحترمونها وذلك بأن يعمل للناس كما يعملون له، وينفعهم بمقدار ما ينتفع بهم، ويحرم عن الانطلاق والاسترسال في العمل على حسب ما يحرمهم فليس له أن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد بل هو حر فيما لا يزاحم حرية الآخرين، وهذا حرمان عن بعض الحرية للحصول على بعضها. وثانيتهما: أن المجتمع لا يقوم له صلب دون أن يجري فيه سنن وقوانين يتسلمها الأفراد المجتمعون أو أكثرهم تضمن تلك السنن والقوانين منافعهم العامة بحسب ما للاجتماع من الحياة الراقية أو المنحطة الردية، ويستحفظ بها مصالحهم العالية الاجتماعية.
وعن علاقة الحريتين الخاصة والعامة بالاصلاح يقول العلامة السيد الطباطبائي في تفسيره الميزان: ومن المعلوم أن احترام السنن والقوانين يسلب الحرية عن المجتمعين في مواردها فالذي يستن سنة أو يقنن قانونا سواء كان هو عامة المجتمعين أو المندوبين منهم أو السلطان أو كان هو الله ورسوله على حسب اختلاف السنن والقوانين يحرم الناس بعض حريتهم ليحفظ به البعض الآخر منها، قال الله تعالى: "وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ" (القصص 68)، وقال تعالى: "وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا" (الأحزاب 36). فتلخص أن الإنسان إنما هو حر بالقياس إلى أبناء نوعه فيما يقترحونه لهوى من أنفسهم، وأما بالنسبة إلى ما تقتضيه مصالحه الملزمة وخاصة المصالح الاجتماعية العامة على ما تهديه إليها وإلى مقتضياتها العلل والأسباب فلا حرية له البتة، ولا أن الدعوة إلى سنة أو أي عمل يوافق المصالح الإنسانية من ناحية القانون أو من بيده إجراؤه أو الناصح المتبرع الذي يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر متمسكا بحجة بينة، من التحكم الباطل وسلب الحرية المشروعة في شيء. ثم إن العلل والأسباب المذكورة وما تهدي إليه من المصالح مصاديق لإرادة الله سبحانه أوإذنه على ما يهدي إليه ويبينه تعليم التوحيد في الإسلام فهو سبحانه المالك على الإطلاق، وليس لغيره إلا المملوكية من كل جهة، ولا للإنسان إلا العبودية محضا فمالكيته المطلقة تسلب أي حرية متوهمة للإنسان بالنسبة إلى ربه كما أنها هي تعطيه الحرية بالقياس إلى سائر بني نوعه كما قال تعالى: "أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ" (آل عمران 64). فهو سبحانه الحاكم على الإطلاق والمطاع من غير قيد وشرط كما قال: "إن الحكم إلا لله" وقد أعطى حق الأمر والنهي والطاعة لرسله ولأولي الأمر وللمؤمنين من الأمة الإسلامية فلا حرية لأحد قبال كلمة الحق التي يأتون به ويدعون إليه، قال تعالى: "أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ" (النساء 59)، وقال تعالى:"والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر" (التوبة 71).
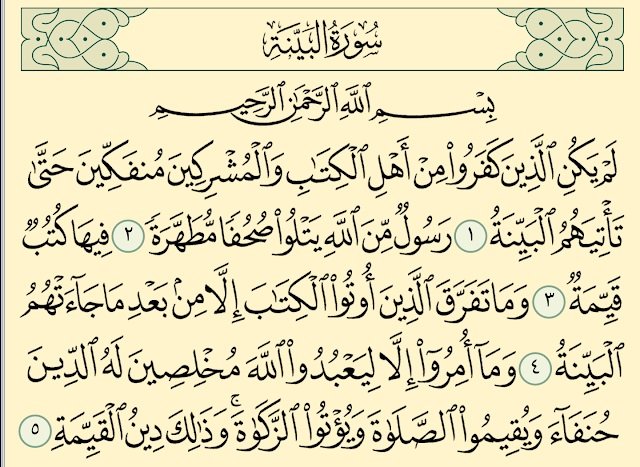


التعليقات
لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!