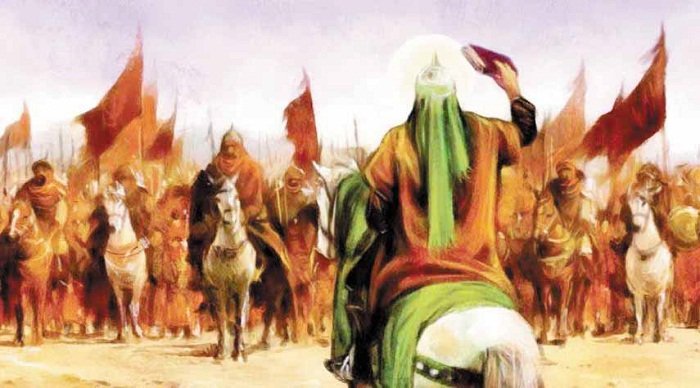الإعلان الأول لثورة الإمام الحسين عليه السلام كان حين طلب منه والي يزيد على المدينة الوليد بن عتبة بن أبي سفيان أن يبايع يزيد بالخلافة، فأبى الإمام عليه السلام ذلك، وما كانت نفسه القدسيّة لتقبل أن تبايع يزيد المشهور بالفجور، وهو الإمام المصطفى من قبل الله عزّ وجلّ لحمل الرسالة بعد استشهاد أخيه الحسن عليه السلام، فأجاب الوالي قائلاً: (( إنّا أهل بيت النبوّة، ومعدن الرسالة، ومختلف الملائكة، بنا فتح الله وبنا ختم، ويزيد رجلٌ فاسق، قاتل النفس المحترمة، معلنٌ للفسق، ومثلي لا يبايع مثله، ولكن نصبح وتصبحون، وننظر وتنظرون، أيّنا أحقُّ بالخلافة والبيعة)) .
رفض الإمام عليه السلام علناً مبايعة يزيد، وخطابه كان موجهاً لوالي يزيد على المدينة مباشرة، فضلاً عن ذلك، فإن الإمام عليه السلام ذكر فضائل أهل البيت عليهم السلام، وإنهم بيت النبوّة ومعدن الرسالة، وإن الله سبحانه وتعالى بهم فتح وبهم ختم رسالاته، ثمّ بعد ذلك سفّه يزيد، وذكر أفعاله التي لا تنتمي إلى الإسلام، فهو فاسق معلن للفسق وشارب للخمر وقاتل للنفس المحترمة، ولم يكن عليه السلام يَأْبَهُ بوالي المدينة أو خليفته يزيد، فقول الحقّ أسمى من التزلّف لهم، أو الركون لسطوتهم الدنيوية الزائفة.
ثمّ ختم عليه السلام خطابه بقوله: "ومثلي لا يبايع مثله"، فلا يمكن للإمام الحسين أن يبايع هذا الفاسق المعدوم من كلّ القيم الإنسانية، ولا توجد هناك أدنى مقاربة بين الشخصيتين، فشخصيّة الإمام التي هذّبها رسول الإسلام بكل القيم النبيلة، ونهلت من أبيه أمير المؤمنين كلّ الخصال والمثل العليا، لا يجوز لها أن تضع يدها بيد هذا الفاسق المجرم، فكانت سمة الأنفة من القبول بالظلم والشجاعة في قول الصدق متجليّة بوضوح في خطاب الإمام لوالي يزيد.
لقد كشف الإمام في خطابه عن الوجه القبيح لبني أميّة، وأنهم لا يمثّلون الإسلام، وأن خلافتهم لم تكن إلا فلتةً أفرزتها الفتن التي ألمّت بواقع الإسلام بعد وفاة النبيّ محمد صلّى الله عليه وآله، وكانت إرادته واضحة وعزمه كبير في مواجهة خلافة يزيد، في قوله عليه السلام: "ولكن نصبح وتصبحون، وننظر وتنظرون، أيّنا أحقُّ بالخلافة والبيعة"، فكان عليه السلام كأنّه يكشف عن حجب الغيب في قوله، فهو لم يقصد الخلافة والبيعة الظاهرية الدنيوية التي لا تمتدّ إلى أكثر من سنين معدودة على عدد الأصابع، إنما كان هدفه أبعد وغايته أسمى، إنّها بيعة القلوب التي تتّحد فيها أيّام الدنيا بأيام الآخرة، لقد حرّر الإمام النفوس من قرارتها والأرواح من أبدانها، وأصبح أميراً لها على مدى الأزمان والأحقاب، ولم ينل يزيد سوى الخزي في الدنيا والآخرة، والاحتقار الشديد من قبل كلّ الأحرار على مدى التاريخ.
واستمرّ الإمام عليه السلام في رفضه لبيعة يزيد علناً، ولم يتنازل عن موقفه وهو بعد في مدينة جدّه رسول الله صلّى الله عليه وآله، فعندما قابله مروان بن الحكم في أحد طرق المدينة، عرض مروان بيعة يزيد على الإمام ثانيةً، فنهره الإمام وسفّهه وسفّه خليفته يزيد، ولم يكن يخشى شيئاً، والذي جرى أنّ الحسين عليه السلام خرج من منزله فإذا هو بمروان بن الحكم قد عارضه في طريقه، فقال (( أبا عبد الله، إنّي لك ناصحٌ فأطعني ترشد وتُسدّد، فقال الحسين: وما ذاك، قل حتّى أسمع؟ فقال مروان: أقول: إنّي آمرك ببيعة يزيد فإنّه خير لك في دينك ودنياك، فقال الحسين: إنّا لله وإنّا إليه راجعون، وعلى الإسلام السلام إذ قد بُليت الأمّة براعٍ مثل يزيد، ولقد سمعت جدّي رسول الله صلّى الله عليه وآله يقول: الخلافة محرّمة على آل أبي سفيان. وطال الحديث بينهما فقال الحسين: ويحك يا مروان أتمدح يزيد وتقول باطلاً؟! ولو أنّ أهل المدينة دفعوا معاوية عن الخلافة وبقروا بطنه وعملوا بما أمرهم رسول الله لما ابتلاهم الله بيزيد )) .
كان إباء الإمام الحسين وإصراره على مناجزة يزيد أكبر من مؤامراتهم وزيف أفكارهم، وقد ظنّ مروان الخبيث أنه قادر على استمالة الإمام بتزويق الكلام، وأن الإمام سيركن إلى دعواهم خشيةً ورهبةً من سلطانهم، ويُنبأ هذا الظن عن جهلهم وخسّة نفوسهم التي تجهل الإسلام ومعانيه العظيمة، فلم يكن الإمام عليه السلام ليخاف أحداً، إنّما كان كلّ خوفه على الإسلام أن تضع فيه آل أميّة ما ليس منه، أمّا يزيد الذي أصبح خليفة فهو العدوّ الأوّل للإسلام في نظر الإمام عليه السلام، لذا صعّد من مواجهته بإن ذكر أن الرسول صلّى الله عليه وآله حرّم الخلافة على آل سفيان، وأبطل خلافة معاوية الذي استخلف يزيد من بعده، وبيّن أن المسلمين تقاعسوا عن بقر بطنه كما أوصاهم الرسول صلّى الله عليه وآله إذا رأوه على منبره، فكان نتيجة ذلك أن صار يزيد خليفة عليهم.
يمكن عدّ ما حدث في المدينة في أيّام استخلاف يزيد هو بداية إعلان الثورة، فالرفض الشديد من قبله عليه السلام لخلافة يزيد أمام واليه على المدينة وأمام مروان هو الشرارة الأولى لهذا الإعلان، فالموت أهون على الحسين عليه السلام من المبايعة التي يرى فيها ذلّاً للإسلام والمسلمين، فكان هذا الرفض ينطق بكلّ السمات الروحيّة لشخصيّته عليه السلام، من الإباء والإرادة والصدق والشجاعة.
وأشاع الإمام عليه السلام أن الركون إلى مبايعة يزيد يعدّ كفراً، وليت المسلمين كانوا يفقهون إشاراته الواضحة بعدم أحقيّة يزيد للخلافة وهو شارب الخمور وراكب الفجور، وصرّح بذلك حينما زار قبر جدّه الرسول صلّى الله عليه وآله يريد وداعه بعد أن قرّر ترك المدينة والتوجّه إلى مكة، ففي حديث عمّار، أنّه قال عليه السلام: (( بأبي أنت وأمّي يا رسول الله، لقد خرجتُ من جوارك كرهاً، وفُرّق بيني وبينك، وأُخذتُ قهراً أن أبايع يزيد، شارب الخمور، وراكب الفجور، وإن فعلتُ كفرت، وإن أبيتُ قُتلت، فها أنا خارجٌ من جوارك كرهاً، فعليك منّي السلام يا رسول الله )) .
فعزم الإمام الحسين عليه السلام على المواجهة كان كبيراً، وخطّط لترك المدينة والتوجّه إلى مكة ليوسّع من قاعدة المعارضة، فلن تقبل نفسه العظيمة أن يرى يزيد الفاجر جالساً على منبر الرسول صلّى الله عليه وآله، أراد أن يلقي الحجّة على المسلمين جميعاً، فقد اختار طريق الثورة الذي لا بدّ منه من أجل الدفاع عن الإسلام وإعادة الحق إلى نصابه، ولو كانت نفسه الشريفة تذهب فداءً في سبيل ذلك.
وحدّد الإمام عليه السلام أهداف قضيته ومحاورها الأهمّ في وصيّته لأخيه محمد بن الحنفيّة ورسالته إلى بني هاشم حين خروجه من المدينة، وكتب في وصيّته لأخيه ابن الحنفيّة: (( بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به الحسين بن علي بن أبي طالب إلى أخيه محمّد المعروف بابن الحنفيّة، أن الحسين يشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأن محمّداً عبده ورسوله، جاء بالحقّ من عند الحقّ، وأن الجنّة والنار حق، ( وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ ) .
وأنّي لم أخرج أشراً، ولا بطراً، ولا مُفسداً، ولا ظالماً، وإنّما خرجت لطلب الإصلاح في أمّة جدّي صلّى الله عليه وآله وسلّم، أريد أن آمر بالمعروف، وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدّي وأبي علي بن أبي طالب، فمن قبلني بقبول الحقّ، فالله أولى بالحقّ، ومن ردّ عليَّ هذا، أصبر حتّى يقضي الله بيني وبين القوم بالحقّ، وهو خير الحاكمين، وهذه وصيّتي يا أخي إليك. ( وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ) )) .
بيّنت وصيّته عليه السلام قضايا محوريّة مهمّة دعت الإمام عليه السلام إلى الخروج، وقد تجلّت فيها كلّ السمات الروحيّة والكمالات المعنويّة، وكان يُؤكّد على أهداف معيّنة أراد إيضاحها للمسلمين جميعاً، فهي وإن كانت موجّهة إلى أخيه محمّد بن الحنفية إلا أن المقصود بها عامّة المسلمين، ومن هذه الأهداف:
- استهلّ وصيّته عليه السلام بالشهادتين، وبالإقرار بأن ما جاء به النبيّ صلّى الله عليه وآله حقّ، وكان يقصد ذلك، لأنه يعلم أن أعداءه بلا مروءة وسوف يتّهمونه بالخروج عن الإسلام، وهذا ما حصل فعلاً، فسرعان ما أشاعوا أن الحسين عليه السلام يقاتل طمعاً بالخلافة، وقد خرج عن إمام زمانه ولا بدّ من القضاء عليه وعلى فتنته.
- أكّد الإمام عليه السلام أن الهدف الرئيس لخروجه هو طلب الإصلاح في أمّة جدّه، ونفى أن يكون قد خرج أشراً أو بطراً أو مفسداً أو ظالماً، وهو بهذا يُريد أن يحاكم العقل الإسلامي في تلك المرحلة الحرجة، فأبان عن نيّته عليه السلام، وأنه لم يسعَ من أجل ملك دنيويّ أو منافسة في سلطان، إنّما طلبه الإصلاح بعد أن أفسد بنو أميّة وجعلوا الإسلام مطيّة لأهدافهم الدنيئة.
- أكّد الإمام أنّ إرادته مسخّرةٌ لأجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والسير بسيرة جدّه النبي وأبيه الإمام عليهما صلوات الله، وكان يؤكّد عليه السلام على استعمال لفظة (جدّه) ليبيّن للناس قرابته من الرسول صلّى الله عليه وآله، وأنه يسير بسيرة النبوّة العظيمة، وطريق الإمامة المتمثّل بأبيه علي بن أبي طالب عليه السلام.
- لقد أوضح الإمام الحسين عليه السلام مفهوم الحقّ دفعاً للبس الذي وقع فيه المسلمون، فالقبول بإمامته عليه السلام قبول بالحق، وردّها ردٌّ للحق، فهو الإمام والوريث الشرعي للنبوّة، كما نصّ عليه الرسول صلّى الله عليه وآله بأحاديث متواترة، فإنه (( لم يقل: فمن قبَلني لشرفي، ومنزلتي في المسلمين، وقرابتي من رسول الله، وما إلى ذلك...لم يقل شيئاً من هذاـ إنّ قَبوله يكون بقبول الحقّ فهذا داع من دعاته، وحين يَقبل النّاس داعي الحقّ فإنّما يقبلونه لما يحمله إليهم من الحقّ والخير لا لنفسه، وفي هذا تعالٍ وتسامٍ عن التّفاخر القَبلي الذي كان رأس مال كلّ زعيم سياسي أو ديني في عصره عليه السلام )) .
- ثمّ ذيّل الإمام رسالته بقوله تعالى: (( وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ))، وكان المقصود ليس هذا الجزء من الآية الشريفة فقط، إنّما ما سبقها، فقد قرن نفسه عليه السلام بالنبي شعيب عليه السلام، الذي كان يريد الإصلاح لقومه أيضاً، قال تعالى: (( قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ)) .
وأمّا كتابه عليه السلام إلى بني هاشم، فكان على إيجازه البليغ يحمل معانيّاً واسعة أوجزت أهداف حركته عليه السلام، وبيّنت نتائجها وآثارها في القريب العاجل، وفي الأزمان التالية حتّى يظهر الحق، وهذا نصّه: (( بسم الله الرحمن الرحيم، من الحسين بن علي بن أبي طالب، إلى بني هاشم، أمّا بعد: فإنّه من لحق بي منكم استشهد، ومن تخلّف لم يبلغ مبلغ الفتح والسلام)) .
لقد علم الإمام الحسين عليه السلام أن بني أميّة قاتلوه لا محالة، ولن يتركوه وشأنه إن لم يبايع يزيد، وعلم أيضاً أن في قتله تنتهي أسطورة إسلام بني أمية، وتنكشف حقيقتهم، فأقدم على التضحية والفداء من أجل الإسلام، فكان استشهاده عليه السلام هو الفتح لأمّة محمد صلّى الله عليه وآله بالخلاص من دسائس بني أميّة، وفعلاً كانت كربلاء هي الفتح المبين، الفتح الذي اجتاح العقول والقلوب، وإلى الآن تضحيات الإمام عليه السلام في كربلاء تفعل فعلها في نفوس الأحرار وتجذبهم إلى طريق الحقّ، وترفع عن أعينهم غشاوة الباطل.
كأنما كتاب الإمام عليه السلام لأهله من بني هاشم قد كشف الحجب عن الغيب، فلا يمكن بلوغ الفتح إلا ببذل هذه الدماء المقدّسة، فالناس قد رجعت عن الإسلام واطمأنت إلى الحياة الدنيا حينما رضيت بيزيد الفاجر خليفة للمسلمين، فمن يوقظها من غفتلها؟ ومن يحرّك وجدانها؟ فكانت ثروته عليه السلام هي البركان الذي هزّ عروش الظالمين، وأبان عن الحقيقة الساطعة، حقيقة الإسلام المحمّدي الأصيل.
لقد خطّط الإمام عليه السلام لثورته بدقّة، وألزم الجميع الحجّة، قبل خروجه من المدينة متوجّهاً إلى مكة، فلم يكن يدعو إلى نفسه، بل كان يدعو إلى إصلاح دين جدّه صلّى الله عليه وآله، بعد أن رأى أعداءَ الإسلام من آل أميّة يسوسون الناس بالمنكر، ويتبجّحون أنّهم خلفاء النبيّ، فكانت ثورته الفتح المنتظر الذي أعاد للإسلام مكانته في النفوس وطهّره من ادّعاءات أهل الرجس، فتجسّدت في شخصيّته عليه السلام كلّ السمات الروحيّة العليا ليكون المنقذ للرسالة المحمديّة من ضلال آل أميّة.